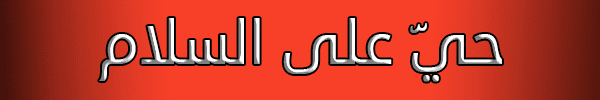جيل البدويات القديمات مهدّد بالانقراض .. من نهبَ زينتهنّ؟ – شاهر جوهر
نساء مارَسنَ الزينة بكامل الحرية رغم بداوة الريف وتصلّبه

يبدو أنني خلال سنوات ماضية أسأت فهم الكثير من الأمور، من تلك الأمور ما كنت أعتقده اعتقاداً لا يميل الى باطل، كشخص ظن أنه امتلك الحقيقة، خصوصاً حول نسوة من حولي في الريف هنّ اليوم حرفياً مهددات بالانقراض، كنوع نادر من الزهور البرية حاصرها القحط فأصبح العثور عليه عسيراً.
سناك سوري _ شاهر جوهر
أقصد ذاك الجيل من النسوة الماكثات على حافة البلاد وعلى حافة المدن و العيش، وهنّ اليوم حرفياً على حافة الوطن لكنهنّ لم يكنّ يوماً على حافة المدنية.
هناك رابطة مألوفة تربطني بتلك النسوة. رابطة تضج بالود، ممن لا زلنَ يرتدين أثواباً سميكة يطلق عليها شعبيّاً “شرش أو كلابية”. ويتفضلن رؤوسهنّ دوماً بعُصابة تسمى “طُفخة” كنمط شعبي بات الوقوف عنده نادراً.
فمن حسن حظنا أننا ولدنا بين هذه المخلوقات النورانية اللطيفة. ومن سوئه أننا قد نكون شاهدين على انقراضه. فالانهيار وحده ليس مقلقاً، فهكذا انهيار هو حدث في سلسلة انهيارات ذاتية أخرى.
الجميل أنهن كن يمارسن زينتهن كنوع من أنواع المهارة والحرية الذاتية وكنوع من الرضا بسعادة ضيقة. بدءاً من الوشوم إلى الأقراط.
أمي -أحد أعضاء هذا الجيل- تمتلك وشماً جميلاً يأخذ شكل سيّال أسفل شفتها السفلى. وآخر على معصمها يأخذ شكل إشارة صليب معقوف. وبقربه نقطة من على ميل أرادت منها في صباها أن تكون مقذوف حربي لطائرة. ووشمها هذا في بدائيته وفي كلّه الحلو أشبه بإشارة لمدفن روماني قديم لا لطائرة كما أرادت أن تكون. وأنا حين أستاء من مزاحها لأناقتي أذكّرها بوشمها ممازحاً بالقول «يا أم طيّارة».
كذلك جدتي لأبي. هي أيضاً مثل جميع النسوة البدويات في جنوب البلاد تضع وشماً يأخذ شكل التاج الملكي أسفل جبينها. تماماً في المكان الذي تتصالب بها عينيها العسليتين الحلوتين. أما جدتي لأمي فوشمها مبالغ به كسيدة بدوية، فقد رسمت على كامل لحيتها ذقناً متدرجة. وهي موضة انتشرت بين النسوة في الستينات.
في حداثة صباي كنت أتعجّب من مساحة الحرية التي كنّ يمارسنها بالوشوم والزينة. رغم بداوة الريف وتصلّبه شاهر جوهر
حتى جميع نسوة جيرتي من لم تتوارَ عنهن الملاحة ولا الظرف مثل الحاجة “عمشة” والحاجة “عيشة” و “رحمة” و”عايشة” و”صبحة” و”عسيلة” وكل تلك البدويات الجميلات كن يتزينّ بلطف ويجمّلن أنوفهن أيضاً بقرط في الأنف يسمى “شناف”.
قبل بضعة سنوات فقط كنت أشاهدهنّ في كل مكان -على ندرتهن اليوم- في الجلسات الصباحية في الحي، في الأعراس، في الأرض، في التربة، في المراعي، في خبز التنور، في كل حالات النهار، كزهور القيقب حاضرات في كل الفصول، ولو منحنّ بعضاً من رفاهية لكنَّ تفتحنَ في الصقيع.
خلال الثمانينات والتسعينات أصبحت زينة تلك النسوة تأخذ محتوى رجعياً من قبل جيل عاش أزمة منتصف جيلين، وقد بالغ هذا الجيل – ونحن في أغلبنا منه_ حين اعتبر زينتهنّ حالة عصية على الحداثة وتؤرق الأخلاق. في حين أنهنّ لازلنَ يؤثرنَ السكوت حيال من ينتقدهنّ من ذاك الجيل.
أنا كذلك لطالما في حداثة صباي كنت أتعجّب من مساحة الحرية التي كنّ يمارسنها بالوشوم والزينة. رغم بداوة الريف وتصلّبه، ولازلت أعجب في ذؤابة هذه الأيام حين أسير في دروب العاصمة أو في أزقة وأحياء أوروبا فألقى مما ألقاه وقد نُهبت زينة أمي وجدتي ونسوة من جيرتي ممن سكنّ الخيمة في يوم ما. مع فارق الدقة بالوشوم وشكل الأقراط بآخر صرعاتها.
لهذا من حيث الملكية الفكرية فهي منهوبة من جيل قلنا جميعاً عنه في وقت سابق أنه متأخر عن الحداثة أو أنه حركة شعبية لبدويات قديمات.
النساء البدويات الممتلئات والمكتنزات تحت أثوابهن العريضة. هذه الكائنات الرقيقة المهددة بالانقراض هنّ أول الشهود وآخر الناجين ولربما هنّ من أسّسنَ لهذه الملكة الأنيقة لهذا الجيل المغرق بالاكسسوارات بعيداً عن برامج الحِمية القاسية والسلفي والفلتر وجَلْد السوشل ميديا.
فيا لها من قصة بائسة. ذات مساء ألقيت القبض على قنفذ وخبأته في سطل بقعر عميقة. حتى أتمكن في الصباح من معاينته، وهو فعل أفعله دوماً كبدوي سيء. لكنه قَلَبَ السطل واختبأ في الكرم، فعلت الفعل عينه مرة أخرى وفعل هو الفعل عينه مرة أخرى. رغم أني وضعت حجراً كبيرة فوق السطل. هذا ما يفعله المرء في بلادنا، فهو بسجيته كاشتراكي خيالي يسعى دوماً ليخفي تلك البدويات عن المجتمع. لاعتبار واحد وأساسي أن الوضع الاجتماعي للشخص يؤثر على معرفته، مع ذلك كان يفشل فيخرجنَ، لأن كل شيء هنا في هذا الكرم لهنّ، وسيبقى لهنّ.
فلتتذكروا هؤلاء النساء، كل شيء حولنا لهنّ، الأرض لهنّ والسماء لهنّ، العادات لهنّ والحياة، لهنّ الخير والبساطة التي تحرق وجداننا حين سماعها. لأننا سنبكي يوماً على رحيلهنّ.