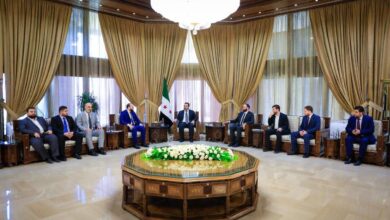لا يزال قانون الجمعيات الناظم لعمل المجتمع المدني،والصادر في خمسينيات القرن الماضي عقب تأسيس «الجمهورية العربية المتحدة» برئاسة جمال عبد الناصر، والذي قيَّد العمل المدني في الإقليم الشمالي (أي سوريا)، يَحكم سوريا إلى اليوم.
سناك سوري
يقول أحد المتطوّعين سابقاً في مبادرة محلّية في مدينة حمص، إن قانون الجمعيات الحاكم للمجتمع المدني جعل مبادرة لمجموعة شبابية من أجل تنظيف حديقة الحيّ، تحتاج إلى تراخيص حكومية وموافقات أمنية، يتطلّب الحصول عليها جهداً يكفي لتنظيف 10 حدائق. الأمر الذي أحبط بعض المبادرات الشبابية ودفعها إلى التوقّف، أو البحث عن جمعيات تحتضنها وتمنحها الغطاء للقيام بأنشطتها، لكنّها في الوقت عينه تسلبها التقدير المعنوي من خلال تغييب خصوصيتها لصالح أسماء هذه الجمعيات. أمّا تلك التجمّعات والمبادرات التي لا تجد لها جمعية حاضنة، ولا تتوفّر لديها القدرة على تأسيس جمعية، فهي «محظورة» بحسب تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية في دمشق عام 2020، يطلب من المحافظين «منع عمل مجموعة مبادرات»، منها ما له علاقة بالتعقيم في حمص استجابة لتفشّي وباء «كورونا»، وأخرى نظّمها درّاجون، خاصّة بالدراجات الهوائية وتشجيع استخدامها. فكيف الحال بمبادرات وتجمّعات تعمل على قضايا أكبر، كمحاربة الفساد وإعادة الإعمار أو المناصرة والتشبيك، وغير ذلك؟
القانون الذي تجاوزه الزمن.
قانون الجمعيات والمجتمع المدني سوريا
يفرض القانون على أيّ جمعية أو مبادرة، الحصول على ترخيص، الأمر الذي يحتاج إلى استطلاع رأي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكلّ جهة لها علاقة بالترخيص. وفي حال رفض الطلب، فإن الجهة الإدارية نفسها هي التي يجب تقديم الاعتراض لديها، وليس القضاء، أي أنها هي الخصم والحَكَم. كما يفرض القانون السجن على أصحاب أيّ جمعية يمارسون نشاطاً من دون ترخيص، فيما الحصول على الرخصة لا يعني نهاية العلاقة مع الجهة الإدارية التي يجب إعلامها بكلّ اجتماع، ويحقّ لها تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، بل وأيضاً حلّ الجمعية، في قرار لا يكون قابلاً للطعن حتى عن طريق القضاء، وهو ما يناقض الدستور. كذلك، تمنع تعاميم لاحقة للقانون تشكيل جمعيات نسائية، وتحصرها بـ«الاتحاد النسائي» التابع لحزب «البعث»، والذي تمّ تشكيله عام 1970، إلّا أن هذا الاتحاد حُلّ عام 2017، وبهذا لم تَعُد هنالك أيّ منظّمة غير حكومية في سوريا، مرخّص لها، تهتمّ بقضايا المرأة وحقوقها، ما يؤكّد تأخر القانون في الزمن، فضلاً عن اعتباره غير منسجمٍ مع الدستور السوري الصادر عام 2012، والذي كان يَفترض تعديل كلّ القوانين للتوافق معه خلال مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
اقرأ أيضاً: سوريا.. بأوج أزمات المحروقات فريق الدراجات عاجز عن نيل ترخيص!
بين «عقليّتَين»
يقع المجتمع المدني في سوريا بين «عقليّتَين» حكوميّتَين: الأولى تراه أداة من أدوات التدخّل الناعم في شؤون البلاد السياسية، معتمدةً على تجارب مِن مِثل تجربة أوروبا الشرقية، وعلى وقائع كالتمويل السياسي لبعض المنظّمات داخل سوريا بعد عام 2011، أمّا الثانية فتراه من دون جدوى أو معنى، وهذه الأخيرة أدّت، بحسب رئيس «حركة البناء الوطني» – مقرّها دمشق – أنس جودة، إلى «إقصاء المجتمع المدني، وبالتالي تغييب آليات التوافق الاجتماعي، ومخمّدات الصدمات في المجتمع، ولذا تحوّلت الشكاوى المجتمعية غير المسموعة إلى احتقانات ثقافية واجتماعية، توسّعت وتراكمت حتى ولّدت الانفجار». ولذا، يشدّد جودة على ضرورة «تفكيك هاتين العقليّتَين، وتحرير المجتمع المدني وتوسيع مروحته، ليس ليلعب دوراً بديلاً عن الحكومة كما حدث في بعض المراحل والمناطق بعد عام 2011، بل ليكون شريكاً لها في خلق موارد اقتصادية واستثمار ديناميته الاجتماعية في استجلاب الاستثمارات، وتعظيم الموارد الداخلية المهمّشة، في وقت انحصر فيه تفكير ودور الحكومة في ضبط النفقات، بدل خلق الموارد وانتظار حلّ يأتي من مكان ما»، لافتاً إلى وجود «مساحات واسعة يمكن للمجتمع المدني العمل فيها إلى جانب الأدوار التقليدية الحالية، تبدأ من المناصرة والمدافعة إلى الرقابة على الفساد، والتشاركية والتخطيط في مرحلة إعادة الإعمار، وصولاً إلى التنمية وصناعة استقرار مستدام والوصول إلى التعافي». على أن الأداء الحكومي، إلى الآن، يُظهر وجود توجّه لتقزيم دور الجمعيات، وحصره في نطاق «خيري» بحت، بحيث توزّع الجمعية سلّة إغاثة هنا، وتساعد مشرّداً هناك، وفي أحسن الأحوال تقوم بالدعم النفسي والأنشطة الترفيهية. وعلى رغم أهمية هذه الأنشطة، إلّا أنها ليست كفيلة بحلّ المشكلات العميقة الأخرى، كما أنها لا تعكس الدور الذي يمكن للمجتمع المدني القيام به، والاحتياجات المجتمعية في ظلّ الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 10 سنوات.
مبرّرات الخوف..
إزاء ذلك، يعتقد البعض بضرورة وجود قانون للمنظّمات غير الحكومية، يفسح المجال أمام أشكال متنوّعة ومرنة من المبادرات المجتمعية. لكن تحقيق هذا المطلب يحتاج، برأي جودة، إلى «غطاء وقرار سياسي داخلي بالاعتماد على المجتمع المدني كشريك»، وهو ما لا تبدو الحكومة مستعدّة له، في ظلّ مخاوفها من استثماره في التمويل السياسي الخارجي. وتبرّر الحكومة مخاوفها تلك بما جرى خلال سنوات الحرب، حيث سُجّل تمويل منظّمات ومناطق بعينها، فقط لأنها خاضعة لسيطرة الفصائل المسلّحة، فيما قُطع هذا التمويل، الذي يُفترض أنه مخصّص لتلبية احتياجات الناس، عن مناطق سيطرة الحكومة، الأمر الذي تجلّى مثلاً في الغوطة الشرقية، حيث بلغ حجم التمويل الخارجي الذي كان يدخل إليها شهرياً نحو 10 ملايين دولار. إلّا أن جودة يرى أن «القانون الشفّاف والواضح، الذي ينظّم التمويل والعمل، من شأنه أن يحلّ هذه المشكلة، من خلال تبديده لخوف المنظمات والفاعلين المدنيين، وبمجرّد زوال الخوف تحضُر الشفافية، وهذا يتطلّب مساحات عمل وحرية في تنفيذ المشاريع، تحت مظلّة البرنامج الذي يضعه المجتمع المدني»، بما يتيح «استقطاب التمويل الخارجي عبر آليات شفافة وواضحة، ومشاريع معلنة»، وأيضاً «تحفيز المموّل الوطني للعب دور، بدَل آلية القيود الأمنية الحالية التي عجزت عن ضبط التمويل الأسود».
المصدر: جريدة الأخبار – بلال سليطين
اقرأ أيضاً: منظمات المجتمع المدني والشائعات – ناجي سعيد